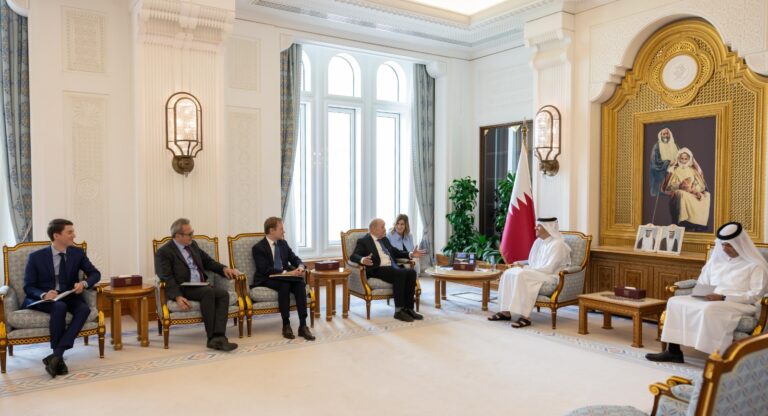مهاجرون سوريون جاؤوا عبر المتوسط الى اليونان. الصورة عن الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي.
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
نظم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الاميركية في بيروت ندوة حول كتاب “تأملات وهجرات” المتعلق بالهجرة الى اوروبا وخصوصا للسوريين وهو بإشراف الاستاذة الجامعية الدكتورة أمل نادر والمترجمة في شؤون اللاجئين جيمي بولس حيث ناقشتا الكتاب الصادر عن “لارماتان” منذ قرابة الشهرين.
الصائغ: أزمة تغذي اليمين المتطرف
شارك بالنقاش المؤرخ مروان أبي فاضل، والدكتور روي جريجيري استاذ الاعلام في الجامعة اللبنانية. وقدّم الندوة الباحث في معهد عصام فارس زياد الصائغ الذي قال بأن “هذه الطاولة المستديرة تتناول اشكالية الهجرة واللجوء في الفضاء الأورو-متوسطي، وأهمية طرحها في المرحلة الحالية انطلاقا من تعاطي مختلف الدول المتوسطية والأوروبية، دول العبور والوجهة، مع هذا القديم والمتجدد في ظل تفاقم أزمات الشرق الأوسط وما تثيره من مخاوف تغذي اليمين المتطرف والنزعات الشعبوية في اوروبا. تراجع نقاش في موضوع اللجوء او النزوح في لبنان منذ انطلاق ثورة 17 تشرين ولكنه عاد الى الواجهة في الاسبوعين الماضيين من بوابة ما اصطلح على تسميته بـ”صفقة القرن” الذي يعنى به اللاجئون الفلسطينيون تحديدا، ومن ثمّ عودة النقاش في كلفة النزوح السوري على لبنان وفي المكانين سمعنا مواقف شعبوية وهذا الامر لا يقتصر على لبنان لأنه حتى في اوروبا نعيش موجات من الشعبوية في مقاربة قضايا الهجرة تحديدا لا سيما في المنطقة الاورو متوسطية”.
تركز النقاش حول التعاطي السياسي والتغطية الاعلامية، ثم اهمية اختيار التسميات او التوصيفات التي تكتسب ابعادا سياسية وتاريخية في المخيّلة الجماعية، وتمت مناقشة التحديات بالنسبة للقدرة على الاستقبال والسياسات والتشريعات وتم تناول تبادل الخبرات بين دول البحر الابيض المتوسط لأن من بين المساهمين بالكتاب مجموعة دول متعددة، الحوض الجنوبي والحوض الشرقي والحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط.

نادر
ركّزت الدكتورة أمل نادر على مسألة التعاطي السياسي والتغطية الاعلامية لقضية تدفق المهاجرين في اوقات الحروب والازمات والتحديات المشتركة بالنسبة للأوروبيين او بالنسبة لمنطقة جنوب حوض المتوسط. وفنّدت الهواجس الاوروبية مشيرة الى أن “ازمة تدفق المهاجرين هي من اكبر واصعب العقد وهي موضوع خلافي بامتياز في ظل ارتفاع نسبة البطالة، ونمو الحركات الاسلامية الراديكالية، وازدياد التهديد الارهابي من الجهاديين الآتين او العادئين من مناطق الحروب، والمندسين احيانا بين المهاجرين، اضافة الى التفجيرات الارهابية التي طالت اكثر من عاصمة اوروبية. هذه النقطة ساهمت في تعزيز التيارات اليمينية المتطرفة والنزعات الشعبوية او الانعزالية المعادية للهجرة، التي تبني ايديولوجيتها على التخويف من الآخر. بما ان اغلب الوافدين هم من السمسلمين فإن الاختلاف الثقافي والديني الذي هو بالأساس عامل اثراء يتحول الى عامل خوف”.
وقالت ان التعاطي الاوروبي مع موجات الوافدين منذ 2015 جاء على مرحلتين: في المرحلة الأولى كان التعاطي ايجابيا، وكان التوجه السياسي يميل الى احتضان طالبي اللجوء وخصوصا الهاربين من مناطق النزاع. هذا التوجه السياسي جاء منسجما مع الرأي العام الأوروبي المتعاطف والمرحب في البداية.(…) هذا الموقف الايجابي لم يدم طويلا بسبب صعود اليمني المتطرف” فكان لا بدّ من امتصاص هذه الظاهرة بشكل طارئ، اولا عبر محاولة استيعاب الوافدين، وثانيا من خلال السعي الى تلزيم دول جنوب حوض المتوسط كليبيا والجزائر والمغرب وتركيا مهمّة الحد من التدفق وتقنين وصول المهاجرين الى الحدود الأوروبية. وهنا جاءت فكرة “المناطق الساخنة” التي هي بمثابة المصفاة للفرز، لتكون بذلك الهجرة مختارة لا مفروضة بالنسبة لدول الشمال. لكن هذا المقترح لاقى انتقادا واسعا كون معظم دول الجنوب وعلى رأسها ليبيا، لا تحترم حقوق الانسان ومن غير الواضح كيفية ادارتها لهذا الملف. ثم لا ننسى ان اوروبا منقسمة فيما بينها سياسيا، ودولها تعاني من تفاوت اقتصادي واضح، ومداخل اوروبا مثل (ايطاليا اسبانيا واليونان) هي من بين الدول التي تطالها الازمة الاقتصادية اكثر من غيرها، وان كانت اليونان على رأس القائمة. هذه الدول تجد نفسها ملزمة على تحمّل اعباء الوافدين اكثر من غيرها بحكم الامر الواقع. اضف الى ذلك ما تنص عليه معاهدة دبلن القاضية بإعادة كل طالب لجوء الى اول دولة اوروبية وضع فيها بصماته لتقديم طلبه، كل هذه الفوارق تجعل اوروبا عاجزة عن وضع سياسة موحدة للهجرة وتحقيق توزيع عادل بين الدول على اساس الحصص”. وتحدثت عن خصوصيات كل دولة اوروبية وشرق اوسطية خاتمة “بضرورة تلاقي المقاربات بين دول الانطلاق ودول العبور ثم دول الوصول وتبادل وجهات النظر والتوصل الى وضع سياسسات تكون عابرة للدول والحدود، كذلك عصرنة التشريعات ووضع قوانين للهجرة تحاكي تطور العصر مع خلق المقومات الضرورية للاندماج في المجتمع من طرف الدول المضيفة، او من طرف الوافدين انفسهم دون محاولة صهرهم ومحو هوياتهم”.
بولس وقوانين اللجوء الفرنسية
وتحدثت المترجمة جيمي بولس وهي مشاركة لنادر بكتابة “تأملات وهجرات” عن قانون اللجوء الذي أثار وما زال يثير مواجهات بين الدولة والجمعيات التي تعنى باللاجئين
ثم عن تجربتها الشخصية كمترجمة فورية في مجال اللجوء والآليات المتبعة في فرنسا لاستقبال اللاجئين. واستهلت مداخلتها بلمحة عن اجراءات اللجوء في فرنسا. وقالت بولس:”
وهنا لا بد من تعريف أبرز الكلمات المفاتيح في طلب اللجوء ألا وهي
مهاجر، لاجئ، الأوفبرا، حماية أساسية، حماية احتياطية، محكمة اللاجئين…
عندما يصل المهاجر الى الأراضي الفرنسية لا يكون له صفة شرعية لأن مصطلح “مهاجر” ليس مصطلحًا قانونيًا، هو “يعيّن ببساطة الأشخاص الذين يغادرون بلدهم بالاختيار أو الضرورة أو الإكراه، للذهاب في بلد آخر والاستقرار فيه”. عندما يصل المهاجر إلى بلد ويبدأ إجراءات طلب اللجوء يصبح “طالب لجوء”، مما يعني أن البلد المضيف أصبح مدركًا لوجوده على الأرض ولم يعد يعيش مختبأ.
بينما “اللاجئ” له وضع قانوني وحقوق.
الأوفبرا، المركز الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، هي الإدارة الفرنسية الوحيدة المؤهلة درس طلبات اللجوء واعطاء الحماية أو رفضها. هي مستقلة تماما عن أي ادارة فرنسية أخرى ولا يستطيع أحد التدخل في قراراتها.
البلدان التي تتصدر طلبات اللجوء في فرنسا هي: ألبانيا، ساحل العاج، غينيا، هاييتي، بنغلادش كونغو، جورجيا، نيجيريا، أفغانستان وباكستان.
أن درس ملف اللجوء يتم عبر مقابلة سرية بين طالب اللجوء وموظف الحماية بحضور مترجم عند الحاجة طبعا.
تدرس الأوفبرا الملف وترسل القرار عبر بريد موثّق. والنتيجة تكون أما
حماية أساسية لعشر سنوات وهي أعلى درجات الحماية
أما حماية احتياطية لأربع سنوات تعطى لأسباب انسانية أو رفض للحماية.
أما محكمة اللاجئين فهي السلطة الأعلى في فرنسا التي تستطيع أن تنقض قرار “الأوفبرا” في 2018 سجلت المحكمة أكثر من 50000 طلب طعن وقدمت الحماية لما يقل عن 9 آلاف شخص”.
كي تستطيع كل من الأوفبرا ومحكمة اللاجئين معالجة موجة المهاجرين من مختلف الجنسيات هي بحاجة الى مترجمين ، يلعبون دورا أساسيا في اجراءات اللجوء.
في المحكمة والاوفبرا هنالك 466 مترجم محلف يتكلمون 110 لغات مختلفة.
ولفتت بولس الى ان” الدولة الفرنسية تتعامل مع طالب اللجوء كانسان الانسان أولا والجنسية ثانيا، ومع ذلك يبقى قانون اللجوء في بعض الأحيان ظالما في حق المهاجرين”.
وشرحت جيثيات خطة المهاجرين التي أنتجت قانون اللجوء في فرنسا الذي تمّ تعديله في المرة الأخيرة في 10 أيلول 2018.
قالت:” هنا انتقل الى قانون اللجوء منذ عام 1980، هو قانون الهجرة واللجوء الثامن والعشرين.
أثارت قضية رعاية المهاجرين الكثير من النقاش بين الحكومة والجمعيات. استقبل رئيس الوزراء إدوارد فيليب حوالي 30 جمعية للسكن والمساعدة للمهاجرين في ماتينيون. اجتماع يهدف إلى تخفيف التوترات بشأن “خطة المهاجرين”. يدّعي رئيس الحكومة أنه “سمع” مطالبهم وأحيانًا خيبة أملهم. أعلن إدوارد فيليب منذ ذلك الحين عن إنشاء “مشاورات ” حول مشروع قانون الهجرة في المستقبل في كانون الثاني 2018 وحول انشاء “مجموعة مراقبة” لتعداد المهاجرين ما دفع الجمعيات بتصنيفه بمحاولة “فرز” لهؤلاء.
تشكل الجمعيات قطبًا مهمًا في رعاية المهاجرين. لا يمكن لفرنسا الاستغناء عن مساعدتها، كانت المفاوضات معقّدة لإيجاد حل وسط أو حل يرضي جميع الجهات الفاعلة على أرض الواقع وكذلك سياسة الحكومة الجديدة.
يقترح “مشروع قانون الهجرة ” التي تم الإعلان عنها في 12 يوليو 2017:
- إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في دافع الوصول الى سكن دائم”.
- الترحيل الفوري عندما يرفض طالب اللجوء, في عام 2016 ، “غادر نحو 25000 شخص البلاد” من أصل 31000 قرار ترحيل فوري
- تقليص مدة الإجراءات لطلب اللجوء إلى ستة أشهر أو حتى ثلاثة أشهر, ونجحت نوعا ما الأوفبرا في تحقيق ذلك
- تطوير الاندماج عبر تكثيف دروس اللغة الفرنسية المقدمة للاجئين
- دعم أوروبا: خطة المهاجرين تؤكد أخيراً الالتزامات الأوروبية؛ الجهود الرامية إلى “إعادة توطين” اللاجئين من بلدان العبور (لبنان، تركيا …)، ووضع سياسة لجوء مشتركة وإجراءات ضد المهربين في إفريقيا.
- تعيين مندوب مشترك بين الوزارات لإدماج اللاجئين يكون مسؤولاً عن تنسيق وصول الأشخاص المعاد توطينهم في فرنسا وتنظيم الاستقبال في ظروف جيدة.
- تمديد فترة الحجز قبل مرحلة الترحيل من 45 يوم الى 90 يوما علما أن هنالك قاصرين في مراكز الحجز. في عام 2012، تم احتجاز 99 طفلاً في فرنسا، ليصل مجددا في سنة 2017 الى 275، رقم قياسي بحسب الجمعيات المدافعة عن حقوق الاطفال.
- اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون، في 28 أغسطس 2017، خلال قمة مصغرة مع الأطراف الرئيسية في أزمة الهجرة، إقامة “مناطق ساخنة” في النيجر وتشاد من أجل تحديد المهاجرين المؤهلين لطلب اللجوء. تهدف القمة إلى الحد من تدفق المهاجرين العابرين عبر ليبيا والبحر الأبيض المتوسط. أراد بذلك إيمانويل ماكرون تنفيذ “تعاون في مسائل الأمن والعدالة” وفرض وجود عسكري على الأرض من أجل منع المزيد من التداعيات غير المباشرة وزيادة التدفقات إلى ليبيا”.
يغادر معظم المهاجرين بلادهم على أمل مستقبل أفضل، لكنهم يقعون بسرعة في خيبة الأمل. خيبة الأمل بسبب الصعوبات المادية والمالية والإدارية الخاصة بكل بلد وبشكل خاص فرنسا.
على باب اوبيرفيلليه في باريس تم تفكيك مخيذم للاجئين في 27/01/2020 كان يحوي على أكثر من ألف لاجىء أغلبهم ممن حصلواعلى أوراقهم وبعضهم مجبر على الترحيل بحسب قانون دبلن.
ختاما :
في عالم اليوم مفاهيم مثل العولمة، والتقدم التكنولوجي، والرأسمالية، وتغير المناخ، والحروب الأهلية هي جميعها عوامل متناقضة تجعل العالم، وخاصة أوروبا، يواجهون الى اليوم هذه الموجة من المهاجرين. للخروج دائما أقوى في ظل هذه الموجات، سيكون من الضروري إعادة النظر في الأيديولوجية التاريخية لاستيعاب المهاجرين، والتركيز على التكامل والتعددية الثقافية. نستشهد هنا بأقوال كاثرين ويتول دي ويندن، وهي من كبار الباحثين في مجال الهجرة، تقول إن” التعددية الثقافية هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على هوية فرنسية قوية وحيوية، وهي في الوقت نفسه مفتوحة للتحديات الجديدة المتمثلة في العولمة والهويات الثقافية وتدفقات الهجرة، تنوع الأديان، وجذب الروابط المجتمعية، والشبكات المحلية بدلاً من قمع تاريخ وثقافات وتقاليد ولغات اللاجئين”.
أبي فاضل
وتحدث استاذ التاريخ الدكتور مروان ابي فاضل عن موضوع :” المشرق العربي معاناة تاريخية مع اللجوء القسري”. ولفت الى أن “الجغرفيا تفرض نفسها على تاريخ الشعوب وعلى نشأة الدول وتطورها وابداعاتها الحضارية،
كذلك تخضع الجغرافيا الشعوب لمظالم قاسية، لعلّ من أسوأ مظاهرها التهجير القسري الذي يولّد مشاكل لا تمحى، وتتعرض مناطق اكثر من غيرها لهذه الظاهرة المدمرة. وفي نظرة سريعة الى تاريخ المشرق العربي الذي يضم لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والاردن، يتبين لنا حجم المأساة المتتالية من أقدم العصور التاريخية وحتى يومنا هذا”.وعدد المعاناة من1 زمن الملوك الآشوريين والبابليين الذين كانوا يجلون كليا او جزئا الشعوب المقهورة الى بلاد ما بين النهرين بغية اضعاف قوة الاعداء ثم زمن الفرس سنة 539 ق.م. “حين ارتكبت حالات تنكيل بالبابليين وتم قتل الآلاف منهم وتهجيرهم”، ودخل الشرق الادنى حقبة جديدة من تاريخه مع الاسكندر المقدوني بعد سنة 333 ق.م.، وهو “اتبع كمن سبقه سياسة الغزوات والتهجير، فانتصر على الفرس في معركة “إيسوس” وانفتحت امامه طريق سوريا وفينيقيا حيث كانت تقيم بعض الحاميات الفارسية. لكنه واجه مقاومة في صور، فحاصرها سبعة أشهر، ثم احتلها عام 332 ق.م. ونكّل بأهلها وقتل اعدادا منهم. ثم تابع السير جنوبا، فقاومته مدينة غزة فحاصرها ودمّرها”. واستمرت معاناة التنكيل والتهجير في حقبة التاريخ الوسيط (القرن السابع-القرن السادس عشر)، في عهد الخلفاء الراشدين بدأت الفتوحات العربية\الاسلامية، وانتصر العرب على البيزنطيين في معارك عدة، وافتتحوا بعدها مناطق سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وشمال افريقيا. كذلك حاربوا الساسانيين وانتصورا عليهم وافتتحوا العراق وايران وامتد نفوذهم حتى حدود الهند والصين”. واكمل ابي فاضل عرضه التاريخي عن عهد عمر بن الخطاب، والخليفة العباسي المنصور، والهجمات الصليبية،وعصر المماليك ثم دخول الشرق الاوسط حقبة التاريخ الحديث بعد انتصار العثمانيين وضمهم بلاد الشام عام 1516 ومصر عام 1517. يضيف:” كانت للحروب الداخلية اثرها الكبير في تهجير السكان كما حدث في جبل لبنان سنة 1711، عندما اندلعت حرب فاصلة في عيرن دارة بين القيسيين واليمنيين وانتصر القيسيون وقتلوا عددا كبيرا من اتباع الحزب اليمني وزعمائهم،وهجروا بعض النازحين الى حوران حيث اصبحوا يشكلون جالية درزية قوية هناك”. وعرّج على ازمات لبنان الداخلية في القرن التاسع عشر وتدخلات خارجية ادت الى اندلاع فتن طائفية بين السنتين 1841 و1860، وكان اشدها ما حصل سنة 1860، حيث تعرض آلاف المسيحيين في جبل لبنان الجنوبي والبقاع للقتل والتهجير، كذلك انتقلت الاحداث الى دمشق، حيث تعرض نحو ثمانية آلاف مسيحي للقتل وآلاف غيرهم للتهجير القسري، فانعقد مؤتمر دولي في بيروت حضره مندوبون من الدول الكبرى: فرنسا، انكلترا، روسيا، النمسا، بروسيا، والسلطنة العثمانية. ومبعد مشادات عنيفة، توصل المجتمعون الى وضع نظام سياسي جديد للبنان”. وخلال الحرب العالمية الاولى (1914-1918)، تعرض جبل لبنان لحصار بري عثماني، ترافق مع حصار بحري فرضه الحلفاء على السواحل الخاضعة للسلطنة العثمانية، فعانى لبنان مجاعة قاتلة اودت بحياة الآلاف من سكانه، فضلا عن حركة نزوح واسعة، فأفقرت بعض القرى والمدن”. ثم مع نهاية الحرب الاولى سنة 1918 “خضعت المنطقة للانتدابين الفرنسي والنكليزي ولم تشهد الاستقرار المنشود وبرزت مشكلة العصر المتمثلة بهجرة اليهود الى فلسطين بغطاء انكليزي وصدرت قرارات دولية غايتها ايجاد حل للاضطرابات الامنية السياسية ولكنها باءت بالفشل واندلعت حروب اسرائيلية عربية عدة (…). وبعد لجوء الفلسطينيين الى غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والاردن ومصر اثر مجازر الجيش الاسرائيلي وتهجيره للفلسطينيين وتهجيره قرى باكملها كما في قرية دير ياسين شكلت الامم المتحدة منظمة الاونروا لرعاية اللاجئين الفلسطينيين الا ان استمرار الحروب العربية الاسرائيلية ادى الى زيادة معاناة المهجرين الفلسطينيين وقد أدت حرب 1967 الى تهجير دفعة جديدة من الفلسطينيين باتجاه الاردن ولبنان”.
وأضاف ابي فاضل:” يقدّر عدد الفلسطينيين بنحو 7 ملايين نسمة داخل فلسطين التاريخية، إلا ان تحديد العدد ومناطق انتشارهم يبقى بحاجة الى دراسات احصائية دقيقة. فالفلسطينيون العرب في اسرائيل يزيد عددهم اليوم عن المليون، وينتشرون في الداخل في غزة وفي الضفة الغربية. أما في الخارج فنجد تجمّعات كبرى في الأردن ولبنان وسوريا، وعشرات الآلاف في العراق ومصر. كذلك نجد آلاف الفلسطينيين في السعودية والامارات والكويت وليبيا وتونس وغيرها من الدول، وينتشر عشرات الآلاف في ايران وقبرص. ونذكر اخيرا ان آلاف الفلسطينيين يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية وأميركا، وفي بلدان أوروبية عدة. لم تنحصر مأساة التنكيل والتهجير بالفلسطينيين فقط، فقد ذاق مرارا آلاف اللبنانيين الذين عرفوا هجرة مدوية بسبب الحرب التي اندلعت سنة 1975، واستمرت حتى سنة 1990. كذلك عانى آلاف العراقيين التهجير بعد الاجتياح الاميركي سنة 2003، وما تزال المأساة مستمرة بفعل الانقسامات المذهبية والاتنية والتدخلات الاقليمية والخارجية المدمرة. كذلك تعاني سوريا التهجير الذي طال الملايين من مواطنيها بعد الحرب المندلعة منذ سنة 2011. وبعد اندلاع ثورات ما عرف بالربيع العربي سنة 2011، شهدت اوروبا نزوح الملايين من سكان الدول العربية الواقعة تحت تأثير الاضطرابات والحروب الطائفية والعشائرية، وطرحت مسائل مرتبطة بمدى قدرة المهاجرين على اتأقلم مع نمط الحياة الاوروبية وحضارتها، ومدى تقبل الاوروبيين استقبال وافدين يختلفون عنهم، وما تزال هذه المواضيع عرضة لتحليلات ونظريات متعددة”. وختم ابي فاضل:” تركت الجغرافيا تأثيرها على تاريخ شعوب المشرق العربي التي عانت آلام الهجرة القسرية على مدى قرون، ونعلم ان كل تهجير قسري اسبابه الخاصة فلا يجوز تعميم الاسباب والنتائج. إلا ان تحليلا سريعا لواقع اللجوء الحديث، يقودنا الى استنتاج مفاده ان اسباب اللجوء تكون داخلية ناتجة من صراعات طائفية او اتنية بين ابناء البلد الواحد، والحل لهذه المشكلة لا يكون سوى بتطوير النظرة الى الدولة عبر تبني انتماء جديد يقوم على اقامة دولة المواطنة والكفاءة بدل الانتماء القائم على الطائفية والمذهبية والاتنية. أما الاسباب الاخرى لاستمرار المأساة فتعود الى التدخلات الخارجية في المنطقة، ولا يمكن مواجهتها سوى بقيام دول مدنية موحدة تتعلم الدروس من التاريخ وتحمي المواطنين من دون تفرقة من مأساة التهجير القسري وما يتركه من ندوب لا تمحى من الذاكرة الجماعية والفردية”.
جريجيري
وتحدث استاذ الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور روي جريجيري عن موضوع :” المحطات التلفزيونية اللبنانية بين مشكلة اللاجئين واللاجئين مشكلة”.
ومن خلال دراسات لعشرة ايام على 3 محطات تلفزيونية لبنانية هي ال بي سي أم تي في والجديد، توصل جريجيري الى نتائج عدة هي:” مصطلح النازحين شبه حصري في القنوات الثلاث، في تطابق مع الموقف الرسمي، ليس لأزمة اللاجئين السمتجدة أي تأثير تقريبا على مقاربة الملف محليا، اثارة مسألة اللاجئين في لبنان بشكل عرضي ومستقل تماما عن الازمة العامة في قناتي أم تي في والجديد، حيّز في ال بي سي للظروف المعيشية للنازحين الذين يواجهون عاصفة رملية او يتظاهرون امام سفارة المانيت، قصتان عرضيتان عن رضّع يعانون من مشاكل على أل بي سي وأم تي في”. وفي الخلاصات التي قدمها الدكتور جريجيري:” ترتبط التباينات في التغطية المحلية بالحساسية السياسية-الطائفية المحلية: تبدو قناة ال أم تي في قناة مسيحية محافظة أقل دعما نسبيا للاجئين واكثر اهتماما بالوضع يف اوروبا وبتهديد محتمل للهوية المسيحية للقارة القديمة. أما الجديد ذات الهوى اليساري المؤيد لـ”حزب الله” فتنتقد أوروبا وكذلك الدول العربية والخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي غالبا ما تكون في مرمى السياسة التحريرية للمحطة. ويأتي تموضع أل بي سي بين الاثنتين بحسب السياق والموضوع”.